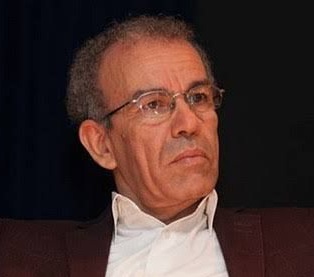من "التجديد" إلى "التحديث"
لـ"التجديد" معنى ولـ"التحديث" معنى آخر؛ إذ لكل من المفهومين سياق نشأة وتطور، كما يرتبط بمنظومة ثقافية وبنسق مفاهيمي وفكري خاص.
يُستعمل مفهوم "التجديد" في الفكر الإسلامي انطلاقاً من الخبر المشهور المنسوب إلى النبي محمد: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها"، وبغض النظر عن الدلالة السياسية الواضحة لهذا الحديث، الذي وُضع أساساً لشرعنة الحركات الدينية المعارضة، إلا أنه على المستوى الفكري فُهم على أنه بعد كل مرحلة طويلة من التحولات المتلاحقة التي يعرفها المجتمع الإسلامي، "يزيغ" الناس عن "النموذج الأصلي" للتدين لفرط ما يطرأ على حياتهم من تغيرات و"بِدع" محدثة، اعتبرها الفقهاء "ضلالات"؛ إذ كلما بعدت المسافة بين المسلمين وفترة النبوة و"التنزيل" كانوا أبعد عن النبع الأصلي وأقل فهماً للدين وأقل اكتراثاً بتعاليمه، بسبب مغريات الحياة المادية وجاذبية المنافع الدنيوية، وبسبب "ضرورات الوقت" التي تفرض على الناس الانصياع لأوضاع جديدة غير مسبوقة في حياتهم. وقد حتّم هذا الوضع ظهور المصلحين والدعاة "المجددين" الذين صارت مهمتهم في كل مرحلة إعادة الناس إلى "صحيح الدين"، ونفض غبار البِدع عن النبع الأصلي، وهكذا صار على المسلمين أن "يعودوا" إلى نماذج السلوك والوعي النمطية التي اختطت منذ البداية، بداية الدعوة النبوية، ويتخلوا عن كثير مما اكتسبوه وانضاف إلى فطرتهم الإيمانية الأولى التي تجعلهم مسلمين منذ الولادة (كل مولود يولد على الفطرة).
وعلاوةً على ما في هذا التصور من نزوع مثالي، حيث لا يعدو أن جعل من صورة البدايات و"الصفاء الأول" صورة متخيلة مبنية على عناصر منتقاة بعناية، فإن اللافت للانتباه هو أثر هذا الفهم "السلفي" للحديث المذكور على الفكر والحضارة الإسلاميين، فقد أصبح للزمن في الوعي الإسلامي شكل دائري ينتهي حيث يبدأ، ويبدأ حيث ينتهي، ليشبه بذلك الثعبان الذي يعضّ ذنبه، ويقصي معاني الصيرورة والتراكم الكمي المفضي إلى انتقال نوعي يجسده التطور والترقي في مدارج الحضارة، والمانع من ذلك التطور والصيرورة هو اعتبار النبع الأصلي ممثلاً لأقصى درجات الكمال والرقي، التي لم تعد تمثل الماضي فقط، بل ما ينبغي أن يكون مستقبلاً أيضاً، لكنه مستقبل معلوم وليس مجهولاً، ولا يتحقق عبر الاكتشاف والمعرفة، بل عبر استعادة وتملك النص المقدس، الذي يتضمن الأجوبة عن كل الأسئلة، لأن كل ما يمكن أن يقال قد قيل، والحقيقة محددة سلفاً وبشكل نهائي ومُحكم.
أدى مفهوم التجديد عكس ما يتصور إلى "انحباس حضاري" دخل معه المسلمون رويداً في عصر ظلمات طويل بعد نهضة نسبية لم تعمر طويلاً، كما يفسر ذلك كيف هيمنت النزعة السلفية على الفقه الإسلامي عبر العصور، فانتقل من تأسيس المذاهب الفقهية الكبرى إلى إنتاج "الشروح" و"الحواشي" و"المتون" التي تدور في فلك ما أنتجه السابقون.
هكذا انبنى صرح الفكر الإسلامي بكل مكوناته على أساس منهجي يعتبر العودة إلى الأصول والقياس عليها (قياس الغائب على الشاهد)، وإرجاع "الفرع" أو "النازلة" إلى "الأصل" الذي تقاس عليه، بغرض الحكم فيها بالتحليل أو التحريم، فنشأ علم أصول الفقه الذي فتح الباب أمام "الاجتهاد" المحكوم بـ"ضوابط" تجعله على الدوام مرتبطاً بالأصل، وسرعان ما تحولت قواعد علم الأصول إلى قوالب جاهزة ومحنطة، جعلت الفقهاء ينتهون دائماً إلى نفس النتائج السابقة، حيث صارت القواعد البشرية جزءاً من الدين نفسه، فقالوا "لا اجتهاد مع وجود نص"، وقالوا أيضاً "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، وواجهوا كل اجتهاد خارج الضوابط بعبارة "رأي شاذ خارج عن إجماع علماء الأمة"، مما جعل الواقع المتحرك محاصراً من طرف الفقه الجامد، الذي حول النص الثابت إلى إطار يتم عبره تحجيم حركية الواقع وديناميته، وأوقع بالتالي المجتمع الإسلامي في التخلف والركود على مدى قرون طويلة.
أما مفهوم "التحديث" فهو من "الحداثة"، الكلمة التي تضم في ثناياها معنى التعارض مع كل ما هو قديم أو جامد، وهي بذلك ترمز إلى المعاني النسبية للتغيير والتجاوز، سواء عبر القطيعة النسبية، أو عبر استيعاب الماضي من خلال نقده في سياق معرفي جديد هو سياق الحاضر الذي يحكمه منطق التطور والرهانات المستقبلية.
إن الفرق بين "التجديد" و"التحديث" إذاً إنما يتمثل في أن الأول اشتغال من داخل المنظومة التقليدية مع مراعاة تامة لمنطقها الداخلي، القائم على ترسانة من المفاهيم والقواعد والمناهج المتوارثة، بينما التحديث هو اشتغال من منطلق الواقع المتغير ذي الأسبقية الحاسمة، ومن الرصيد المعرفي والعلمي الجديد الذي تأسس في الأزمنة الحديثة.
هكذا يُعتبر التحديث تغييراً للمنطق الداخلي لمنظومة الفكر والسلوك، اعتماداً على تطور التجربة الإنسانية، وعلى الوعي النقدي الذي يضع أدوات الفكر ومناهجه ومفاهيمه موضع مراجعة دائمة لا تتوقف.
وما دام المطلوب اليوم ليس تطبيق القواعد المتوارثة بل إخضاعها للنظر النقدي على ضوء روح العصر الذي نحن فيه، فلن يكون لنا من خيار غير إنجاح مسلسل التحديث الفكري والقيمي، ليطابق التحديث المادي الذي يغزو كل تفاصيل حياتنا.