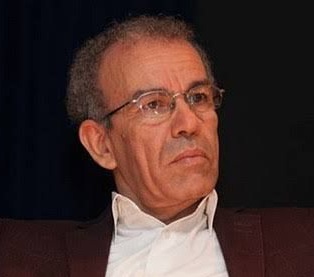الفكر الديني ومفهوم الطفولة
ارتبط مفهوم الطفولة بالأزمنة الحديثة التي أرست مجموعة من المبادئ والقيم المتعلقة بتحديد سن الطفولة وخصائصه الفيزيولوجية والنفسية والعقلية، وقد ساهم في ذلك تطور العلوم الإنسانية والبيولوجية، وتطور نموذج الدولة ومؤسساتها وخاصة منها المؤسسة التربوية؛ حيث اعتبرت سنوات الطفولة لصيقة بالحق في التعليم والتحصيل التربوي الإلزامي، وكان ذلك منطلقاً لاعتبار الكثير من المنظمات الحقوقية والتربوية عبر العالم أن سنّ الطفولة يمتدّ إلى نهاية التعليم الثانوي 18 سنة، بعد أن كان الاعتقاد السائد هو أن الطفولة تنتهي في سن 12 سنة، ليدخل الطفل في مرحلة "المراهقة".
غير أن كل هذه الاعتبارات التاريخية والعلمية والتربوية والاجتماعية لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الفقه الإسلامي المعاصر في العديد من البلدان، وخاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث ظل رجال الدين يفضلون اعتماد النصوص الدينية وتفاسير الفقهاء القدامى وضوابطهم التي كانت ترتبط بمجتمعات لم تعد قائمة اليوم، وهي مجتمعات لم يكن مفهوم الطفولة بمعناه المعاصر قد تبلور فيها، مما أدى إلى إقرار أحكام وضوابط فقهية متناقضة لا تأخذ بعين الاعتبار صغر السنّ وهشاشة الأطفال، فقد اعتمد الفقهاء مثلاً حديث "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ"، ومعنى ذلك أن الصبيّ الصغير لا يُحاسب على كلامه وأفعاله لصغر سنه وعدم بلوغه سنّ الرشد، الذي كان يتحدد آنذاك بظهور بعض السمات الفيزيولوجية؛ حيث لم يكن الفقهاء يعتبرون اكتمال النضج النفسي والعقلي بجانب النضج الجسماني بسبب عدم وجود علوم إنسانية توضح هذه الجوانب آنذاك. غير أن هذا الاعتبار الذي يتضمنه الحديث المشار إليه يختفي تماماً عندما نعلم أنّ الفقه الإسلامي أجاز ما سمّاه الفقهاء "نكاح الصغيرة"، أي الطفلة التي قد تكون بين السادسة والتاسعة، وهي مرحلة سابقة حتى على البلوغ الفيزيولوجي نفسه، ويمكن القول إن ذلك كان ساري المفعول في مختلف الثقافات القديمة؛ حيث تُبرز العديد من الدراسات الأنثروبولوجية والحفرية أنّ ممارسة الاعتداء الجنسي على الأطفال والطفلات منذ أزمان غابرة في تاريخ البشرية كان أمراً متداولاً، كما تدلّ على ذلك العديد من الرسومات والنقوش في الآثار الإغريقية والفرعونية وكذلك الفارسية والرومانية وحتى الصينية.
وقد استند فقهاء المسلمين القدامى، في مواقفهم التي تبدو لنا اليوم في غاية الشذوذ، إلى مرتكزين اثنين: زواج النبي من عائشة وهي طفلة في سن السادسة ودخوله بها في سنّ التاسعة، كما ورد في مراجع الحديث وخاصة "صحيح البخاري"، ثم الآية الرابعة من سورة الطلاق "واللائي لم يحضن"، والتي تمّ تفسيرها على أن الطفلات اللواتي لم يبلغن المحيض معنيات بالزواج والطلاق في هذه الآية. فقالوا إن "الصغيرة التي لَم تَحض يصحُّ نكاحُها". مع العلم أن مفهوم "العِدة" الذي اعتمدته الآية لا ينطبق على الطفلات لعدم إمكان الحمْل عندهن، مما يدل على أن الكثير من المعطيات العلمية المتعلقة بفيزيولوجيا الأطفال لم تكن مستوعبة آنذاك من طرف الفقهاء.
لكن رغم ذلك فقد انبنى على حديث البخاري، وكذا تفسير المفسرين للآية المذكورة، فقه كامل ذهب إلى القول بجواز تزويج الصغيرة مهما كان عمرها إن كانت "تُطيق الجماع"، وأنه لا يُؤخذ رضاها وقبولها بعين الاعتبار إذا زوّجها وليها، ولا خيار لها بعد الزواج إذا بلغت.
يقول ابن بطال في تأكيد ذلك: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد، لكن لا يُمكَّن منها حتى تصلح للوطء"، ويقول: "ويؤخذ من الحديث أنَّ الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها".
وميز فقهاء المسلمين القدامى بين تزويج الطفلة وبين "تسليمها" لزوجها من أجل "الوطء" أي المعاشرة الجنسية؛ فقال بعضهم لا يجوز تسليمها إن لم تكن "تطيق الوطء" أي تتحمل العملية الجنسية، وقد حدّد بعضهم معيار تحمل "الوطء" عند الطفلة الصغيرة أن تكون "سمينة" غليظة الجسم ولو كان ذلك قبل التاسعة، وقال الحنابلة في نكاح الصغيرة في قسوة بالغة: "إذا بلغت الصغيرة تِسْعَ سنين، دُفِعَتْ إلى الزوج، وليس لهم أن يَحبسوها بعد التِّسع، ولو كانت مهزولةَ الجسم، وقد نصَّ الإمامُ أحمد على ذلك".
هذه المواقف والآراء الفقهية قد تبدو لنا غريبة اليوم، لكنها في الواقع ما زالت كامنة وراء الممانعة التي يبديها الدعاة والفقهاء في مختلف بلدان منطقتنا لعرقلة إصلاح مدونة الأسرة والأحوال الشخصية في موضوع سنّ الزواج؛ إذ يبدو واضحاً رغم تغيّر الزمان والمكان حرصُ رجال الدين على عدم تقييد ظاهرة تزويج الطفلات بضرورة إنهاء الدراسة الثانوية؛ حيث تبلغ الطفلة والطفل سنّ 18 سنة، وهم يفعلون ذلك دون أن يبالوا بحق الطفلات في التعليم، بل فقط حرصاً منهم على تطبيق ما ورد في الفقه التراثي، ضاربين عرض الحائط بكل المعطيات العلمية والتربوية لعصرنا، مما يُعرض الطفلات للعنف والضياع بسبب عدم استعدادهن لتحمل أعباء الأسرة وهُنّ في حداثة السنّ.
يُظهر موضوع الطفولة مقدار تخلف الفكر الفقهي الإسلامي عن ركب الحضارة الحالية، ومقدار حرصه على تطبيق آراء فقهية تعود إلى أزيد من ألف عام على حساب الكرامة الإنسانية، ونرى أن دينامية الفكر النقدي، وحنكة الطبقة السياسية والنخب النشيطة، وكذا تحولات المجتمع التي لا يمكن إيقافها، من شأنها أن تُغلب مصلحة الأطفال على سلطة الفقه التراثي على عقول الناس.