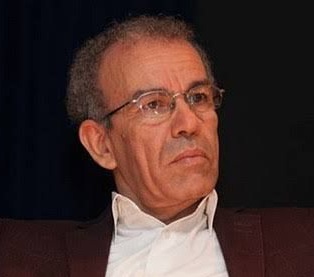المثقف والفقيه
من الناحية النظرية، تتمثل وظيفة المثقف في الاشتغال على الرمزي، وفي البحث عن المعنى، من خلال قراءة الوقائع وأنماط الوعي والسلوك قراءة الناقد المتفحص، وذلك عبر قيامه بجهد التفسير والتحليل والتركيب؛ بهدف الفهم أولاً، ثم إثارة الأسئلة القلقة المسكوت عنها في غالب الأحيان، لتعويض الحس المشترك والتمثلات السائدة بدينامية الفكر الحي، مع التحلي بنزعة إنسية تَعتبر الإنسان في المركز دائماً، ما دام الهدف الأسمى للمثقف هو الرقي بالوضعية الإنسانية نحو الأفضل.
أما الفقيه فهو الذي يحتكر سلطة التفسير والتأويل للنص الديني المقدس، الذي يحفظه عن ظهر قلب، مثلما يحيط بقراءاته وقواعد التفكير فيه كما ورثها عن المذاهب الفقهية القديمة، من خلال ركام هائل من المتون والحواشي والتفاسير والأحكام التي أنتجها الفكر الديني الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري، وبذلك يمكن اعتبار الفقيه مالكاً لـ"فن الأجوبة الجاهزة"، الذي يعمل خارج الزمان والمكان على إعطاء "الفتوى" في كل تفاصيل حياة الأفراد والجماعات، و"ما يجوز" و"ما لا يجوز" في المعتقد والمعاملات وتفاصيل اليوم.
لهذا لم أتقبل شخصياً أن يعتبر الدكتور الراحل محمد عابد الجابري بأن الفقيه هو الذي يمثل نموذج "المثقف" في المنظومة الثقافية التراثية؛ حيث قام بإسقاطٍ غير جائز لمفهوم حديث على وضع ووظيفة متعارضين مع دور الفقيه في ظل الدولة الدينية القديمة. حيث يبدو واضحاً أن الفارق الرئيسي بين المثقف والفقيه هو الحرية، حرية العقل المفكر المستقل عن أي وصاية، وعن أي ثوابت محددة سلفاً، فإذا كان المثقف يعمل على دفع الناس نحو التفكير من خلال استفزاز عقولهم، فإن الفقيه يخاطب مشاعرهم ويدعوهم لشيء واحد هو التسليم والامتثال.
ولقد كان أمراً طبيعياً أن يندلع الصراع بين الطرفين بمجرد ميلاد الدولة الوطنية الحديثة؛ التي كان من أبرز نتائجها ظهور الفرد والفردانية، وبروز دور المثقف بعد أن صارت الدولة في سياق مسلسل العلمنة البطيء والمرتبك تستمد أطرها من الجامعات العصرية والمعاهد الحديثة، ناقلة وظيفة التسيير والتدبير المؤسساتي من رجل الدين إلى موظفين مدنيين، وجاعلة من الفقيه موظفاً في قطاع عمومي هو "الأوقاف والشؤون الإسلامية"، الذي لم يتقبله ولم يُسلِّم به حتى الآن، بل ظل يهفو دائماً إلى استعادة وظيفته القديمة في النُّصح والتوجيه والوصاية على المجتمع.
لكن هذا الانقلاب الجذري في نموذج الدولة وترسانتها القانونية، لم يرافقه إحداث نفس الانقلاب الرمزي على مستوى الفكر والثقافة، مما جعل الصراع حول القيم يندلع بشكل حتمي بين ممثلي التقليد ومنطق الدولة الحديثة والمجتمع العصري الذي يمثله المثقف، حيث ظل الفقيه يخاطب "جماعة المسلمين" في إطار "الأمة"، بينما يعمل المثقف على تأطير "مواطنين" في "مجتمع" يطبعه الاختلاف والتنوع على شتى المستويات، وفي الوقت الذي سعى فيه الفقيه إلى احتكار مفهوم الأصالة والهوية المغلقة، أثار المثقف إشكاليات الانفتاح على الكوني مبرزاً التفاعلات العميقة بين الذات والآخر، والتي كانت وحدها أساس بناء حضارات عظيمة.
في ظل هذا الوضع الموسوم بتوتر دائم، عمد المثقف إلى تفكيك "دوغما" الفكر الديني عبر الفحص النقدي لقواعد العمل الفقهي، كما أخضع الصورة الرومانسية "للبدايات الذهبية" لمشرحة النقد العقلاني والبحث التفكيكي التاريخي والفيلولوجي، بينما عاد الفقيه إلى أسلوبه القديم في محاولة نزع الشرعية العلمية عن أي خطاب علمي لا يسند الخبر إلى النص المؤسس قرآناً أو حديثاً، وهكذا لم يَسلم المثقف المعاصر في المجتمع الإسلامي من "المحنة" التي رافقت الأدباء والفلاسفة والمشتغلين بالعلوم الدقيقة وكل منتجي الخطاب خارج سلطة النص المؤسس، وزاد من تعقيد دور المثقف ظهور طرف ثالث بين المثقف والفقيه التقليدي يمثل تحدياً كبيراً للمثقفين؛ ألا وهو التيار الديني-السياسي الذي لا يعترف بشرعية الدولة الحديثة، وفي نفس الوقت يتخذ موقفاً عدائياً واضحاً من المثقف حامل الخطاب النقدي. ولأن هذا التيار الذي حول الدين إلى أيديولوجيا للصراع على السلطة، يعمل داخل المجتمع مركزاً على الفئات الشعبية العريضة والمحرومة من مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة، وعلى رأسها اقتسام الثروة، فقد صار المثقف العضوي أكثر عزلة أمام انتشار قِيم مضادة للوعي الذي يطمح إلى تعميقه لدى المواطن، لكن كل هذه التحولات لم تمنع المثقف، رغم ذلك، من العمل بإصرار على إلقاء الحصاة القلقة في مستنقع التراث الآسن، مسلحاً بالعلم بمفهومه المعاصر، ومستعيناً برياح التاريخ التي ما فتئت تدفع في اتجاه المستقبل.