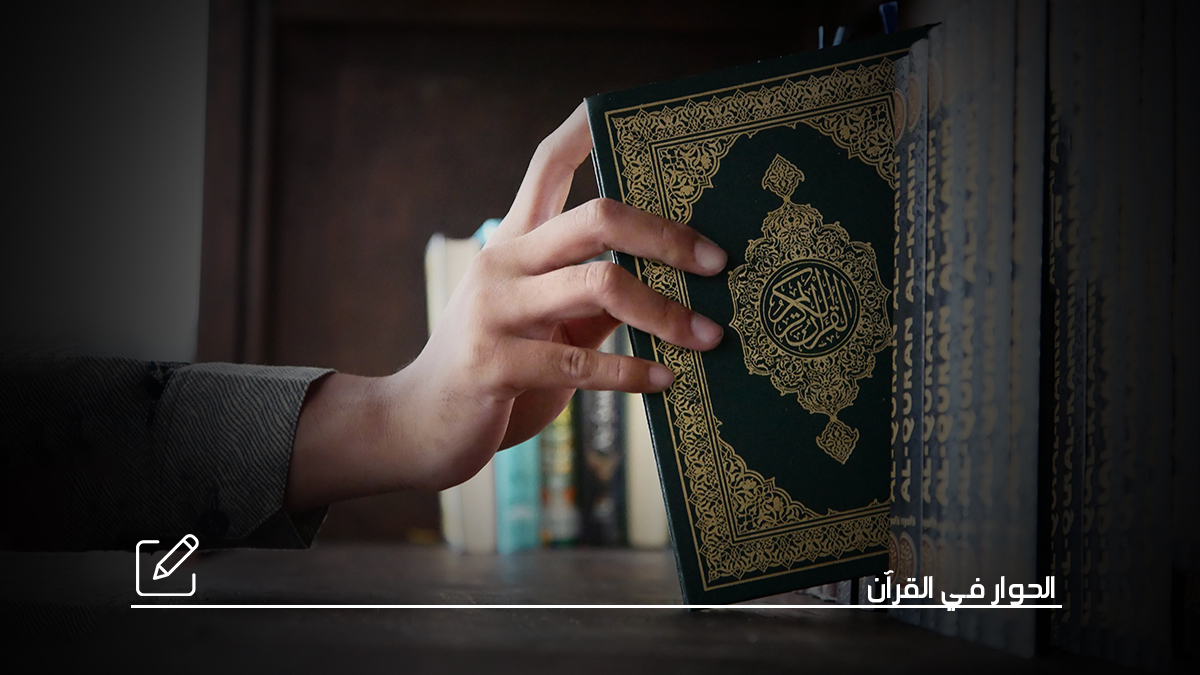يتميّز القرآن الكريم، بوصفه كتاب هداية وتشريع وبيان، بتوظيفه البارع لأسلوب الحوار في بناء المعنى، وتوليد الفهم، وتوجيه الضمير الإنساني. فالحوار في القرآن ليس مجرد وسيلة بلاغية، بل هو بنية معرفية وأخلاقية تعكس فلسفة قرآنية أصيلة في التعامل مع الآخر، وفي عرض الحقيقة، وفي جدل العقل والوجدان.
يتعامل القرآن الكريم مع الحوار كأداة تكوينية للمعرفة، لا كوسيلة صراع أو إسكات. فالمخاطَب في القرآن ليس مجرد متلقٍّ سلبيّ، بل كائن عاقل مسؤول عن فهم ما يُلقى إليه، ومطالب بتفكيره وقراره. من هنا، جاءت العبارات القرآنية التي تستحث على النظر والاعتبار، مثل: ﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾ [البقرة: 44]؛ ومثل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾ [النساء: 82].. وأيضاً، مثل: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [البقرة: 111].
الحوار في القرآن
إنّ منطق "هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ" هو إعلان ضمني بأن الدين في جوهره لا يتهرّب من السؤال، بل يدعو إليه؛ وهذا ما يجعل القرآن يتبنّى أسلوب المجادلة لا الإملاء، والمناظرة لا المصادرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: 125].
بل نجد القرآن لا يمانع نقل كلام الخصم كاملاً، كما في حوارات الشيطان، أو فرعون، أو الكفار، دون أن يُحرّفها أو يبترها، وإنما يعرضها ثم يردّ عليها بالحجة والبرهان، مما يعزز فكرة أن "الحوار" في القرآن الكريم هو مسألة عقيدية أساسية، ضمن المنظور الإلهي لخلافة الإنسان في الأرض.
ومن خلال تتبّع مواضع الحوار في القرآن، يظهر بجلاء أن النص الإلهي جعل من الحوار منهجاً لفهم الذات والآخر والكون، سواء أكان هذا الآخر إنساناً، أو شيطاناً، أو ملَكاً، أو حتى الله عز وجل حين يخاطب خلقه، أو يُنقل حوار سابق بين الخالق وأحد مخلوقاته.
يبدأ أول حوار في القرآن في سورة البقرة، بين الله وملائكته، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]؛ وهو حوار يؤسس لفكرة التساؤل المشروع، والانفتاح المعرفي، حتى مع قضايا الغيب والمشيئة الإلهية. لم يُقابل اللهُ سؤالَ الملائكة بالتوبيخ أو التجريح، بل بالرد والتوضيح "إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ"، مما يعكس عمق أدب الحوار الإلهي، والمدى الذي يصل الحق، سبحانه، في استقبال الحوار العقلاني، ولو مع اعتراض مبدئي.
ثم تتكرر الحوارات في قصص الأنبياء، كوسيلة لإيضاح مواقف الحق، وتبيين زيف الباطل. إذ كل حوار إلهي مع نبي من أنبيائه عليهم السلام يحمل مضموناً معيناً، ويتضمن قضية محددة.
الحوار الإبراهيمي
أحد هذه الأمثلة، الحوار الإلهي مع نبي الله إبراهيم عليه السلام.. وفي ذلك، يأتي قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [البقرة: 260].
وكما نلاحظ، فإن هذا الحوار الإلهي مع نبي الله إبراهيم، يؤكد على مشروعية الحوار، وأن الحوار، هنا، هو شكل من أشكال الاستدلال التوضيحي؛ إذ كان مضمون الحوار بين الله تعالى وبين إبراهيم يتعلق بـ"كيفية إحياء الموتى"، بمعنى أن الاستدلال يختص بـ"الاطمئنان"، وليس بـ"الإيمان": "قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ"؛ أي الاطمئنان إلى أن الله سبحانه سوف يستجيب لطلب إبراهيم، في أن يريه هذه الكيفية.
ومن الواضح أن السياق القرآني لم يتعرض لهذه المسألة، أي إنه لم يتعرض للإجابة عن التساؤل: هل أجرى إبراهيم عليه السلام هذه العملية.. العملية التي يدل عليها قوله تعالى: "قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ" (؟!). وسواء قام إبراهيم بهذه العملية، أم لم يقم بها، أو إنه تيقن دون أن يجريها؛ فإن عدم تعرض التنزيل الحكيم لهذه المسألة يبدو منطقياً، من منظور أن السياق القرآني للآيات السابقة لهذه الآية، يؤشر إلى عدة صور من الحوار الاستدلالي، كان نبي الله إبراهيم، نفسه، أحد أبطال إحداها.
نعني قصة الحوار بين إبراهيم وبين "ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ"؛ يقول سبحانه: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ إِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحۡيِۦ وَأُمِيتُۖ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: 258]. وبصرف النظر عن هذا "ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ"، وسواء كان ملكاً وكان اسمه "النمروذ" كما حاول كثير من المفسرين الإتيان باسمه ووظيفته، أم لا.. فإن الواضح أن الحوار القرآني، يتسم بـ"المنطقية" في الاستدلال على سمات الله سبحانه "العلي القدير"، والقوانين التي وضعها سبحانه لتحكم حركة الكون والإنسان.
مغزى المحاججة
ما يجب ذكره، هنا، أن الله تبارك وتعالى لو كان يريد تشخيص المسألة، كان قد ذكر اسم "ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ"؛ لكنه، سبحانه، أراد جعل الأمر عاماً، أمر التساؤل حول "العلي القدير" والمحاججة بشأنه؛ بل وإمكان حدوث أمر المحاججة في أي زمان أو مكان.. ولذلك لم يأتِ على ذكر الشخص، مثلما أتى –كمثال– على اسم "مريم" الصديقة؛ من حيث إن حالة "مريم" لن تتكرر، في حين أن "المحاججة" يمكن أن، بل وسوف، تتكرر.
ملاحظة أخرى، بخصوص الحوار الإلهي مع إبراهيم، والتساؤل الإبراهيمي حول "كيفية إحياء الموتى"؛ إذ لنا أن نلاحظ كيف ورد في التنزيل الحكيم التأكيد على مسألة "السعي"، وليس "الطيران".. فقد كانت الخطوة الأخيرة في الإجابة الإلهية على طلب إبراهيم، هي: "ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ"؛ بما يعني أن الله تبارك وتعالى قد نقل الأمر من الطيران إلى السعي، رغم أنه من المفروض أن يأتي الطير "طيراً" أو طيراناً.
والواقع أن هذا "النقل" إنما يأتي للدلالة على الاستجابة لطلب إبراهيم في الاطمئنان؛ من حيث إن "السعي" هو "حركة في الأرض لأجل هدف محدد"، وهو الأكثر استدلالاً على التأكد، حيث إن رؤية هذه الحركة تتم عن قرب؛ في حين أن "الطيران" هو "حركة في السماء لأجل هدف محدد"، ورؤيتها تتم عن بعد.
وختاماً، يظهر أن "الحوار في القرآن" ليس مجرد أداة للسرد، بل هو بنية مفهومية تعكس مركزية الإنسان، وكرامة العقل، وحرية الموقف، وحق التساؤل، حتى في أعمق القضايا العقدية. وفي ذلك، يتحول الحوار القرآني إلى دعوة دائمة لتفعيل التفكير، ومواجهة الوهم، والانخراط في مشروع معرفة أخلاقي يرتكز على الكلمة، لا على السيف؛ وعلى الإقناع، لا على الإكراه، بدليل قوله عزَّ من قائل: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [النحل: 125].